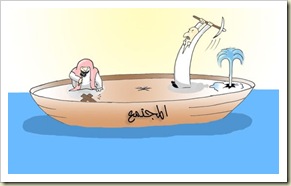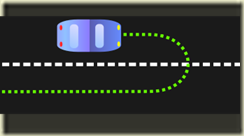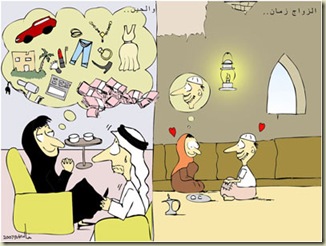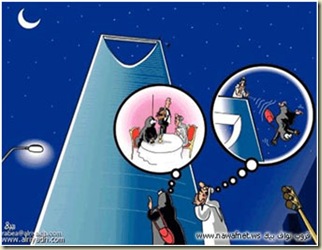الخواجة عزمي: تاجر الذهب، والقبطي الوحيد في مدينتي الصغيرة بمحافظة الدقهلية.
لم أشعر بأي بغض، أو تمايز في طفولتي، أو في صباي نحو هذا الرجل - الذي مات منذ فترة قصيرة – ولم يحدثني أحد من أهل بيتي – المتدين منهم وغير المتدين – بسوء عنه، أو عن عائلته التي كانت تعيش معه. كذلك لم يمتنع أحد من أهل المدينة الصغيرة – الصالح منهم والطالح – عن التعامل معه، بحجة أن الشراء منه حرام، رغم أن تجاراً آخرين من المسلمين في نفس البلدة كانوا يتاجرون أيضاً في الذهب..
كما أني أزهري منذ المرحلة الابتدائية عشت في صباي مع مسلمين فقط، ودرست مواد الدين الإسلامي المختلفة، ولم يغير ذلك من شعوري نحو ذلك الرجل المسيحي الوحيد في صباي.
ولم أر غضاضة أبداً – وحتى الآن - في الشراء من محل تاجر مسيحي، أو في التعامل مع مسيحي في علاقة زمالة، أو علاقة عمل عابرة كانت أم دائمة..
نشأت على ذلك، وأعتقد ذلك رغم أني أحسب أني متدين متمسك بديني وعقيدتي..
إلا أن مخطط "الفوضى الخلاقة" لا يريد أن يبرز هذه الصورة، ولا أن يعممها؛ فهو يهدف إلى إبراز النماذج الشاذة، والمواقف السيئة حتى يتحقق المراد، وتشتعل النيران..
فصرنا نسمع عن "الأقلية المهانة"، ونقرأ توصية بـ "رسالة إلى كل قبطي في مصر ـ حذاري من الأطباء المسلمين"؛ بما يشعرك أن دماء المسيحيين تسيل في مصر أنهاراً، وأن المسلمين يقتلون أطفال المسيحيين، ويستحون نساءهم، وأن المسيحيين لا يأمنون على أنفسهم، ولا على أولادهم، ولا يقدرون على أداء شعائرهم، أو الجهر بها!!
ووازى ذلك حديث قديم جديد عن حتمية إلغاء المادة الثانية من الدستور المصري – والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع؛ لأنها تهين الأقباط؛ لأن الدولة كيان اعتباري لا دين له (!!)، وكذلك الحديث عن حذف خانة الديانة من بطاقة الهوية؛ لأن الدولة المدنية علمانية بالأساس!! ولنا أن نسأل حينها "هل من شروط الوحدة الوطنية أن يكفر المسلمون بشريعتهم" كما يقول الشيخ الغزالي – رحمه الله – في كتابه: "قذائف الحق".
كما استدعي ذلك طلب بإلغاء لكل مظاهر التدين – الإسلامي – من الحياة العامة؛ فاستحالت مقدمة كتاب مدرسي تبدأ بكلمة "بسم الله الرحمن الرحيم" إلى طعنة في قلب الوحدة الوطنية! وصارت إذاعة القرآن الكريم تمييزاً عنصرياً!، وأصبح الاستشهاد على القواعد اللغوية بآية قرآنية إجباراً على دخول الإسلام؛ رغم أن دليل اللغة العربية الأساس هو القرآن، وتناسى الجميع أن "الحوار والعيش الواحد في الوطن الواحد بين أهل الدينين، لا يستقيم بغير احترام الخصوصيات والمشاعر والرموز والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية، ولا يقتصر ذلك على سلوك أبناء كل من الدينين تجاه الآخر، وإنما يعبر عن نفسه كذلك في وقوف الطرفين معاً ضد أي امتهان لمقدسات أي منهما أيا كان مصدره" كما يذكر د/ محمد سليم العوا في كتابه: "للدين والوطن: فصول في علاقة المسلمين بغير المسلمين".
واستتبع ذلك بالضرورة حديث عن مصر القبطية لا العربية، وعن المصريين الأصليين من غير الغزاة العرب الذين أجبروا أهل مصر على دخول الإسلام، وساموهم سوء العذاب! وارتفعت أصوات - كانت هامسة – بأحقية الأقباط في مصر، وطرد الغزاة منها، واستدعاء النموذج الأندلسي في أسبانيا، أو الإسرائيلي في فلسطين، وهو ما يستدعي بالضرورة أن نتساءل مع الشيخ الغزالي: " لقد كانت مصر وثنية فى العصور القديمة، ثم تنصر أغلبها، فهل يقول الوثنيون المصريون لمن تنصر: إنك فقدت وطنك بتنصرك؟
ثم أقبل الإسلام فدخل فيه جمهور المصريين، فهل يقال للمسلم: إنك فقدت وطنك بإسلامك؟"
واستلزم ذلك تزييف التاريخ، والتعمية على نقاطه المضيئة، والبحث بملاقط عن جملة هنا، أو مقطع هناك يتحدث عن اضطهاد يعيش في ظله المسيحيون منذ أربعة عشر قرناً من الزمان!! رغم أن التاريخ يقول – نقلاً عن كتاب "أهل الذمة في مصر" للدكتور/ قاسم عبده قاسم: "وبعد انتصار المسلمين استقدم عمرو بن العاص بنيامين وأمنه، فأخذ ذلك البطريرك – الذي قضى شطراً كبيراً من حياته – في نضال ضد البيزنطيين أعداء الأقباط المذهبيين – يعمل بلا كلل لتقوية الكنيسة اليعقوبية ويعيد تأسيس الأديرة والكنائس التي هدمت قبل الفتح الإسلامي، كما أرسل مطراناً جديداً إلى الحبشة، وكانت آخر أعماله تأسيس كنيسة جديدة للقديس مكاريوس في وادي النطرون (Butcher: The story of the Church of Egypt: vol. I, p. 383)".
كما صارت هناك نغمة سائدة عالية الصوت عن حقوق الأقباط المهدرة في الوظائف العليا؛ وكأن هذه الوظائف متاحة في الأصل لغير الأقباط (!)؛ رغم علم الجميع أن المناصب في الدول الاستبدادية – وبلدنا واحدة منها – حكر على فئة واحدة من ذوي المصالح القريبين من دوائر الحكم، والخادمين له؛ فالمحافظ، والوزير، ورئيس الجامعة، وعميد الكلية، ومدير الأمن، والعمدة لا يتم اختيارهم إلا بمقاييس أمنية قاصرة قد ترى في المسلم الفاسد مصلحة عن المسيحي النافع، أو قد ترى في المسيحي الطالح مصلحة تقدمه على المسلم الصالح.
إلا أن "الفوضى الخلاقة" تحتاج إلى توزيع طائفي للمناصب، لا إلى اختيار حر ديمقراطي.. ولا مانع حينئذ من زيادة ابتزاز الدولة التي صارت ضعيفة أمام جماعات الضغط الداخلي المدعومة من ذوي النفوذ الخارجي حتى تصير "الكوتة" أمراً مسلماً به حين تصبح مصر "عراقاً جديداً"!!
وتفرغت المنظمات الحقوقية القبطية المدعومة للدفاع عن الطائفة، لا للدفاع عن الوطن؛ وانصب جهدها في المطالبة بحقوق المسيحيين وحدهم رغم أن إخوانهم المسلمين محرومون من تلك الحقوق كذلك أو يزيد.
وجرت أقلام مسيحية ولا دينية هنا وهناك تطعن في الدين الإسلامي، وفي أهلية شريعته، وفي الطعن في ثوابته، وقيمه، بما يهيج العامة، ويزيد الاحتقان؛ فيزداد عمق الأخدود، وتعلو الطائفية حتى تحين ساعة الفوضى الموعودة!!
وصار هناك حديث ملتبس عن تكفير المسلمين لغيرهم من أتباع الديانات الأخرى؛ وسار في درب هذا الحديث كل من لا يعرف ديناً، ولا يلتزم بشريعة؛ رغم أن "أهل كل دين يرون غير المؤمنين بدينهم كفاراً بل إن بعض أهل المذاهب والطوائف في الدين الواحد لا يقرون بالإيمان لبعض أهل الطوائف والمذاهب الأخرى داخل الدين نفسه. وهذه خصيصة من خصائص العقائد الدينية، تـَمِيعُ الحدود بين الأديان إذا فقدتها، ويغدو الإيمان بالعقيدة لا معنى له إذا اعتقد صاحبها أن أهل العقائد المغايرة لها على الحق كله، أو على نوع منه، على الرغم مما بينها وبين عقيدته هو ومن تناقض او تضاد" كما يذكر د/ محمد سليم العوا في كتابه سالف الذكر..
كما علا الصوت – تبعاً لذلك - بأن المسلمين يستحلون دماء وأموال وأعراض الكفار من غير المسلمين، ليتم إلباس الحق بالباطل؛ فينخدع غير المسلمين؛ فيرون أن المشكلة في الإسلام ذاته لا في المسلمين الجهّال؛ مع أن كل من له دراية بسيطة بالدين يعلم أن "قضية الإيمان والكفر – هي قضية أخروية – لا يترتب عليها عداوة ولا إباحة دم ولا مال ولا عرض. نعم لو حاربنا قوم على الدين – أو على غيره – حاربناهم، ولو غزونا قاومناهم؛ لا بسبب اختلاف الدين بل بسبب العدوان. وشتان ما بين الأمرين أو الحالين." كما ذكر أيضاً د. محمد سليم العوا.
إنني لا أزعم أن الأمور على ما يرام، أو أن الطائفية تخرج أدرانها من طرف واحد فقط؛ ولكني أزعم أن حقوق الجميع منقوصة، وأن المتمسكين بالسلطة لا يشغلهم إلا البقاء في كراسيهم سواء كان ذلك على حساب هذه الجهة أو تلك..
كما أني أزعم أن ليس للمسلمين جهة رسمية تتحدث باسمهم نستطيع أن نوجه لها اللوم في حديث هنا، أو حدث هناك؛ بعكس المسيحيين الذين تتحالف قيادتهم الرسمية مع النظام الفاسد في العلن في الانتخابات، بنفس القدر الذي تستغل ضعفه في الضغط عليه للحصول منه على مزيد من المكاسب الطائفية.
وإن كنت أزعم أن المفكرين الإسلاميين الكبار (أمثال أ. فهمي هويدي، والشيخ القرضاوي، ود. محمد سليم العوا، وغيرهم) ينتفضون حين يتم تسويق فكرة مغلوطة، أو ترتكب أعمال إجرامية في حق الأقباط؛ في حين أن كبار الكنيسة يزيدون البنزين على النار كما فعل الأنبا توماس عضو المجمع المقدس وأسقف "إبراشية القوصية" حين قال في محاضرة له بالولايات المتحدة الأمريكية: "أن أكبر معضلتين تواجهان المجتمع المسيحي في مصر هما "التعريب" و"الأسلمة"، وأن القبطي يشعر بالإهانةِ إذا قلت له إنك عربي، مضيفًا: "أننا لسنا عربًا ولكننا مصريون، وأنا سعيد لكوني مصريًّا وإن كنتُ أتكلم العربية، ومن الناحية السياسية فإنني أعيش في ظل دولةٍ تم تعريبها وتنتمي إلى جامعة الدول العربية، ولكن ذلك لا يجعلني عربيًّا"، ويقول أيضاً: "أن الأقباط المصريين يشعرون بالخيانةِ من إخوانهم في الوطن "؟"، كما أنهم أدركوا أن ثقافتهم ماتت، ووجدوا أن عليهم أن يحتضنوا هذه الثقافة ويحاربوا من أجلها، حتى يحين الوقت الذي يحدث فيه الانفتاح، وتعود الدولة إلى جذورها "القبطية"، وفي المناخ الراهن فإنه لا يمكن تدريس اللغة القبطية التي هي اللغة الأم لمصر في المدارس العامة، في حين تسمح نظم التعليم بتدريس أي لغةٍ أجنبية أخري." (نقلاً عن مقالة للأستاذ/ فهمي هويدي بجريدة الدستور عدد 22/7/2008).
وأزعم أيضاً أن المسيحيين يزدادون اصطفافاً في خندق منفصل عن إخوانهم في الوطن؛ فصارت منتدياتهم، ونواديهم، ومسارحهم، واجتماعياتهم، وألعاب أولادهم كلها مرتبطة بالطائفة، وصاروا يتلقون الأوامر الصريحة من قادة كنيستهم فيمن ينتخبون، أو متى يتظاهرون، أو فيم يغضبون؛ حتى صارت جل دوائرهم طائفية تستغني عن الآخر، ولا تحتاج إليه!!
إن ما يحدث في مصر الآن من جهل بعض المسلمين بتعاليم دينهم؛ مما يؤدي إلى الإساءة لشركائهم في الوطن، وما تقوم به بعض جهات الطرف الآخر الداعمة لتكرار النموذج الأمريكي الطائفي في العراق بما يعيد إنتاجه في مصر لهو مقدمة واضحة للعيان للفوضى الخلاقة التي يراد لمصر أن تعيشها في الفترة القادمة..
ولا حل لإنقاذ مصر من هذا الخلل، ولحمايتها من هذا العبث، ولاستعادة حق كل مظلوم أياً كان دينه إلا بتطبيق القانون على الجميع سواء بسواء، وبالحرية الكاملة لأهل هذا البلد العظيم لإدارة وطنهم باختيارهم الحر المباشر بعيداً عن فساد الفاسدين، وبطش الظالمين، وبعيداً أيضاً عن أطماع الطامعين..
إخواني.. أخواتي
إن اشتراك البعض في مخطط تفتيت مصر، وتحويلها إلى دولة طائفية لخيانة عظمى تستدعي الأخذ على يد المشارك فيها متآمراً كان أما جاهلاً.